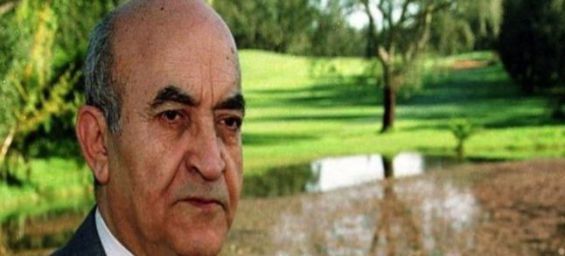العادة أن المقارنات تنبني على السّهولة والاختزال، ولأننا لا نحفل كثيراً بالمرجعيات المتفاوتة والسياقات المُختلفة، فالغالب أنها ظالمةٌ في النتيجة.
الحقيقة، أنه يلزمنا الكثير من الوقت لمقارنة نتائج التجربتين الحكوميتين. لا أحد يعرف ما إذا كانت تجربة بنكيران ستصل إلى مستوى حصيلة حكومة اليوسفي، التي قادت إصلاحا جبّارا لقطاع عام على حافة الإفلاس، وقلّصت إلى أبعد الحدود الدين الخارجي، وأخرجت البلاد من نزيف السكتة القلبية؟ ولا أحد يعرف – في الشّق السياسي للموضوع – ما إذا كان التناوب الثاني سيؤول كسابقه الأول إلى مُجرد حنين غامض تجاه فرصة ضائعة للتحول الديمقراطي؟
لقد جاء اليوسفي إلى الوزارة الأولى وهو يتلمّسُ خُطواته فوق ألغام التسويات الصّعبة وأنصاف الحلول وهشاشة التوافقات، لكن بنكيران وصل إلى رئاسة الحكومة محمولا على أكتاف دستور جعل الحكومة رديفا للسلطة التنفيذية، مُتكئا على أكبر فريق نيابي في تاريخ البرلمان، ومُنتشيا بحرارة الربيع العربي، ومُستندا على حالة سياسية جديدة صنعتها هبّة الشباب المغربي.
في لحظة التناوب الأول كانت معالم الأزمة التنظيمية التي يعيشها الاتحاد الاشتراكي بادية للعيّان، وكانت الفكرة الاشتراكية مُحاطة بالكثير من التشكيك، في حين دخل حزب العدالة والتنمية غمار التناوب الثاني في كامل لياقته التنظيمية، وفي زمن كانت فكرة «الإسلام السياسي»، قد استعادت الكثير من الجاذبية بعد أحداث 2011.
كان اليوسفي مُدججا بكتيبة من الأطر والنّخب الاتحادية، التي تجمع بين الالتزام السياسي والكفاءة التقنية العُليا، في حين لم يتوفر لبنكيران ولحزبه ترف الاختيار الواسع بين الأطر المرشحة للاستوزار.
أراد اليوسفي أن ينتقل من زمن التوافق إلى لحظة الديمقراطية، لكن في المقابل يُصرّ بنكيران على أن يعود من لحظة الديمقراطية إلى زمن التوافق.
كان اليوسفي يريد أن يصنع مساحة سياسية أوسع من رُقعة الدستور، لكن بنكيران يُصرّ على أن يُقلص إراديا ما يمنحه الدستور الجديد من هامش للحركة بحسابات السياسة.
كان اليوسفي يتهم جيوب مقاومة الإصلاح بعرقلة عمل حُكومته، وهو ما يعيده بنكيران مُتحدثا عن العفاريت والتماسيح.
يبدو بنكيران في كثيرٍ من حالاته يُعيدُ – بإصرار عجيب – أخطاء اليوسفي، عندما يُبالغُ في البحث عن الثقة، لكنه في حالات أخرى يبدو – بذكاء لافت- حريصا على عدم السّقوط في أخطاء الزعيم الاتحادي؛ يفعل ذلك عندما يُوازي بين تدبير الحكومة والاهتمام بالحزب، أو عندما يُدبر استراتيجية «الأصوات المتعددة» داخل تنظيمه السياسي، إذ أن حُضور «أفتاتي» و«بوانو» وآخرين داخل المشهد الحزبي للعدالة والتنمية، يذكرنا بالمُخالفة بضيق صدر اليوسفي تجاه «الساسي» و«حفيظ» وغيرهما.
الاختلافات والتشابهات لابد أن تعود كذلك إلى اختلاف الرّجُلين في المسارات وفي الطبيعة؛ بين المُقاوم ومعارض الحسن الثاني والحقوقي البارز، وبين ابن جيل الاستقلال الذي قاد الإسلاميين إلى الادماج والشرعية، بين كاريزما الصّمت وبهاء الحضور المُعتمد على الاقتصاد في اللغة وقوة الخُطب المنطلقة من نصوص «عَالِمة» مكتوبة بحرص محام متمرسٍ، وبين أسلوب آخر يعتمد حُضورا أكثر صداميةٍ، ويتلمس حسّا تواصليا فطريا ولغة شعبية نافذة.
مرّ التناوب الأول سريعا، لتعبر البلاد إلى صحراء الخروج عن المنهجية الديمقراطية، تاركة على الهامش ما تبقى من حزب كبيرٍ قدّم من أطراف جسده المُنهك قرابين غالية فداء حمل «كاذبٍ» بالتغيير!
لا نعرف اليوم – تماما – إلى أين سيمضي التناوب الثاني؟ ولا أي قرابين سيتطلبها هذا الانتقال الذي لا يريد أن ينتهي!





 chargement...
chargement...